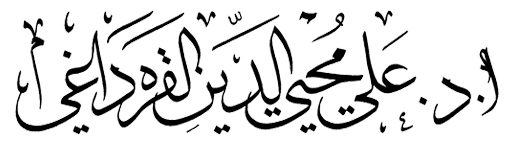لا يخفى أن هذا النوع من السنة مثل القرآن الكريم في الدلالة على الأحكام ، وشمولها لجميع أنواع الدلالة التي ذكرها علماء الأصول من دلالة النص ، وعبارته ، ودلالات الاقتضاء ، والإشارة ، ولحن الخطاب ، وفحواه ، ومن دلالات الأمر ، والنهي ، ونحو ذلك مما يساعد المجتهد على أن يستفيد من النص بعدة اعتبارات ، وأن يستثمره في عدة حقول .
وكذلك تشترك السنة القولية مع القرآن الكريم في جميع المباحث اللفظية الأخرى التي تزخر بها كتب الأصول ، والتي أنتجتها قرائح علمائنا الأصوليين ، ووضعوا لها قواعد دقيقة : من عموم ، وخصوص ، وإرادة الخاص ، ومن إطلاق وتقييد ، وإجمال وبيان لفظي ، وإشكال وتفسير وتأويل ، وخفاء وجلاء ، وحقيقة ومجاز ومشترك ، وصريح وكناية وتعريض ، وما أثير حول مفاهيم الموافقة ، والمخالفة … ونحو ذلك .
كل هذه المباحث اللغوية الخاصة التي ذكروها لألفاظ القرآن الكريم تنطبق على ألفاظ السنة النبوية الشريفة ، لا حاجة إلى ذكرها هنا ، كما أن طبيعة البحث أيضاً لا تسمح حتى بسرد مثال لكل واحد منها ، إذ أننا نريد هنا أن نذكر ما تختص به السنة المشرفة من كيفية دلالتها على الأحكام ، ولذلك لا نتطرق حتى إلى ما تختلف فيه السنة عن القرآن من حيث الإعجاز ، ومن حيث إنه يتعبد بتلاوته ، وأنه لا يمسه إلا المطهرون إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية [1] وذلك لأن هذه الأمور لا تتعلق بكيفية الاستنباط من السنة أو القرآن ، ولا بكيفية دلالتهما على الأحكام .
لكن الذي جدير بالبحث هنا هو أن السنة النبوية تختلف عن القرآن الكريم من حيث الوصول إلينا والثبوت ، فالقرآن كله متواتر وصل إلينا عن طريق التواتر ، إذن فهو كله قطعي الثبوت والوصول إلينا ، وإن كانت دلالته على الحكم قد تكون قطعية إذا لم يحتمل اللفظ غيره ، وقد تكون ظنية إذا احتمل غيره ، وأما السنة فليس كلها قطعي الوصول إلينا حيث إن بعضها قطعي الوصول إلينا ، وهو الأحاديث المتواترة [2] وبعضها الآخر ظني الوصول ــ من حيث هي ــ لكن دلالتها في الحالتين كدلالة اللفظ القرآني على الحكم سواء ، بالإضافة إلى المنزلة العظمى للنص القرآني من حيث كونه ــ لفظاً ومعنى ــ من عند الله تعالى للإعجاز ، في حين أن ألفاظ السنة ليست من عند الله ، وإنما معانيها ، وبالتالي عدم تساويهما في المنزلة والمرتبة ، وإن كان الكل من عند الله تعالى من حيث النتيجة .
وقد ترتبت على ذلك عدة أمور تختلف فيها السنة المطهرة عن القرآن الكريم ، نذكرها بإيجاز ، وهي :
الأمر الأول : اختلافهم في السنة الآحادية مع عدم اختلافهم في القرآن الكريم لأن جميعه ثابت بالتواتر .
وخبر الواحد في الاصطلاح الأصولي هو غير المتواتر سواء كان راويه شخصاً واحداً أو أكثر ، وسواء كان ذكراً أو أنثى ما دام لم يصل إلى حد يستحيل العقل توافقهم على الكذب ، والمراد بخبر الواحد هنا هو خبر الواحد العدل المقبول الذي تتوفر فيه الشروط المطلوبة من قبل علماء الحديث .
وقد اختلف في دلالته وقبوله ، ومدى وجوب العمل به على عدة آراء حيث ذهب جماعة إلى أنه يفيد العلم اليقيني مع وجود القرائن ، في حين ذهب بعضهم إلى أنه العلم اليقيني حتى بدون قرينة ، وهؤلاء اختلفوا على أنفسهم حيث عمم بعضهم هذا القول في جميع أخبار العدول كبعض أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، في حين ذهب بعضهم الآخر إلى أن ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل ، وهذا مذهب بعض أصحاب الحديث .
ولكن جماعة آخرين ذهبوا إلى رأي ثالث وهو أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقاً ، في حين ذهب رأي رابع إلى أن خبر الواحد إنما يكون حجة إذا رواه أكثر من واحد قدره بعضهم بأن يرويه اثنان عن اثنين ، وبعضهم بالثلاثة ، وبعضهم بالأربعة ، وبعضهم بالخمسة ، وبعضهم بالسبعة … في حين ذهبت طوائف من الروافض إلى أنه لا يجب العمل به مطلقاً [3] .
ونحن هنا لسنا بصدد هذه الأقوال ولكن الذي يدعمه الدليل هو أن خبر الواحد العدل ــ بشروطه ــ يفيد الظن من حيث هو ، أما إذا احتفت به القرائن المطلوبة فإنه يفيد العلم ، ولكنه في الحالتين ــ أي مع وجود القرائن وعدمها ــ أوجب الشرع العمل به إذا توفرت شروطه المطلوبة وسلم من المعارضة على ضوء ما ذكره علماء الحديث والأصول [4] .
ويشهد لذلك عدة أدلة من أوضحها إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد العدل والعمل به ، قال الآمدي :” والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة ، ويدل على ذلك ما نقل عن الصحابة من الوقائع المختلفة الخارجة عن العد والحصر ، المتفقة على العمل بخبر الواحد ، ووجوب العمل به ” ثم سرد عشرات الآثار عنهم [5] .
وقد أفاض الإمام الشافعي في الأدلة الدالة على وجوب العمل بخبر الواحد العدل بشروطه حيث ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ، والإجماع ، فقال :” وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت قال الله تعالى : (( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه )) [6] . وقال لنبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : (( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح )) [7] . فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الإعلام التي باينوا بها خلقه سواهم ، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ، ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ومن بعدهم ، وكان الواحد وأكثر منه سواء ً تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر … ” [8] . فهذا دليل على أن خبر الواحد إذا صاحبته قرائن توجب العلم كالمعجزات التي صاحبتهم ، كما ذكر من السنة الكثير منها قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :” نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها ، وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ” [9] ، قال الشافعي :” فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأ ً يؤديها ، والأمرئ واحد ، دلّ على أنه لا يأمر أن يُودَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ، لأنه إنما يُودَّى عنه الحلال ، وحرام يجتنب ، وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى ، ونصيحة في دين ودنيا ” ، ثم أورد عشرات الآثار على أن الصحابة الكرام قبلوا خبر الواحد العدل ذكراً وأنثى واحتجوا به دون تردد مادامت الشروط المطلوبة متوفرة فيه ، وانتهوا القول بأن المسلمين أجمعوا قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه [10] .
كما أورد البخاري كتاباً خاصاً في صحيحه سماه كتاب : أخبار الآحاد ، أورد فيه جملة من الآيات والأحاديث الدالة على حجيتها [11] . ذكر الحافظ ابن حجر أن الأئمة احتجوا بهذه الآيات التي ذكرها البخاري وبغيرها ، وبالأحاديث التي يصل بمجموعها إلى إفادة القطع ، كما أنه قد شاع فاشياً عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير ، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول ” [12] .
هذا وقد أطال العلماء أنفاسهم في ذكر الأدلة ، وفي طرق الرد على المنكرين لا تسمح طبيعة البحث بسردها ، نكتفي بما لخصه إمام الحرمين قائلا ً :” والمختار عندنا مسلكان أحدهما يستند على أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا جاحد ، ولا يدرؤه إلا معاند ، وذلك أنا نعلم باضطرار من عقولنا أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام وتفاصيل الحلال والحرام … وكان نقلهم أوامر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على سبيل الآحاد ، ولم تكن العصمة لازمة لهم فكان خبرهم في مظنة الظنون ، وجرى هذا مقطوعاً به متواتراً لا اندفاع له إلا بدفع التواتر ، ولا يدفع المتواتر إلا مباهت … والمسلك الثاني : مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار الآحاد منقول متواتراً … ” [13] .
الأمر الثاني : هو جواز نسخ القرآن بالقرآن عند جماعة وعدم إجازتهم نسخ القرآن بالسنة .
وهذه المسألة أيضاً مما ثار فيها جدل كبير ، وخلاف عريض ، لا تسمح طبيعة البحث بالخوض فيها ، ولكن الذي نحب أن ننوه به هو أنه وقع خلط كبير فيها نتيجة إطلاق النسخ عند السلف الصالح على التخصيص والبيان ، وتحديده عند الاصطلاح الأصولي على رفع الحكم الشرعي بدليل لاحق حيث أرجع بعضهم توسع السلف في معناه الشامل للمخصص والمبين والمقيد على النسخ بمعناه الاصطلاحي الخاص ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر أن الذي تشهد عليه الأدلة المعتبرة الواضحة أن السنة تأتي بأحكام جديدة وزائدة على ما في القرآن ولكنها لا تعارض القرآن ولا تنسخه لأنها ــ كما سبق ــ [14] أما أن تكون للتأكيد ، أو للتفصيل ، والبيان ــ ويدخل فيهما التخصيص والتقييد ــ وإما أن تكون موجبة لحكم سكت عن إيجابه ، أو محرمة لما سكت عن تحريمه [15] يقول الشافعي :” وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب ، وأن السنة لا ناسخة للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل نصاً ، ومفسِّرة معنى ما أنزل الله منه جملا ً ” [16] . ثم استدل بعدة آيات منها قوله تعالى : (( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إن أتبع إلا ما يوحى إليَّ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم )) [17] . فأخبر الله أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه … وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله : (( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها … )) [18] . فأخبر الله أن نسـخ القـرآن وتأخير إنزاله لا يكـون إلا بقرآن مثـله [19] . ويقـول ابن القيم :” فلا تعارض ــ أي السنة ــ القرآن بوجه ما فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تجب طاعته فيه ، ولا تحل معصيته ، وليس هذا تقديماً لها على كتاب الله ، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ، ولو كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى ، وسقطت طاعته المختصة به … وقد قال تعالى : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) [20] .
ثم إن هذه الأحاديث التي تأتي بأحكام جديدة لا تعتبر نسخاً ــ أي النسخ الاصطلاحي ــ لأن النسخ هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي وليس في مثل هذه الأحاديث نسخ لحكم ثابت بالقرآن الكريم ، وإنما هي بيان لحكم الله تعالى ، على عكس ما ذهب إليه جمهور الحنفية حيث اعتبروا التخصيص نسخاً ، والزيادة على القرآن نسخاً [21] ، ومن هنا لا تجوز إلا إذا كانت السنة متواترة .
وقد انبرى للرد على ذلك كثير من العلماء وأطالوا النفس في الأدلة ، وفي طرق الرد نختار منها ما ذكره ابن القيم بإيجاز سديد ،حيث رد عليهم باثنين وخمسين وجهاً قال فيها :” إنكم أول من نقض هذا الأصل الذي أصلتموه ، فإنكم قبلتم خبر الوضوء بنبيذ التمر ، وهو زائد على ما في كتاب الله مغير لحكمه ، فإن الله سبحانه جعل حكم عادم الماء التيمم ، والخبر يقتضي أن يكون حكمه الوضوء بالنبيذ ، فهذه الزيادة بهذا الخبر ــ الذي لا يثبت ــ رافعة لحكم شرعي غير مقارنة له ، ولا مقاومة بوجه ، وقبلتم خبر الأمر بالوتر مع رفعه لحكم شرعي ، وهو اعتقاد كون الصلوات الخمس هي جميع الواجب ، ورفع التأثيم بالاقتصار عليها ، وإجراء الإتيان في التعبد بفريضة الصلاة ، والذي قال هذه الزيادة هو الذي قال سائر الأحاديث الزائدة على ما في القرآن … والذي فرض علينا طاعة رسوله ، وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته ، وقبول قوله في هذه ، والذي قال لنا : (( وما آتاكم الرسول فخذوه )) [22] هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه ، والله سبحانه وتعالى ولاه منصب التشريع عنه ابتداء ً كما ولاه عنه منصب البيان لما أراده بكلامه ، بل كلامه كله بيان عن الله ، والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه ” .
هذا . ومن وجه آخر أنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ ، وتعارضهما بحيث لا يمكن جمعهما ، مع أن الجمع بين المزيد عليه ، والزيادة ممكن ، كما أن النسخ يقتضي ورود الناسخ والمنسوخ على محل واحد يقتضي المنسوخ ثبوته ، والناسخ رفعه ، ومثل هذا غير متحقق في الأحاديث الآتية بأحكام جديدة زائدة على القرآن [23] .
الأمر الثالث : أن دلالة السنة الآحادية لا ترتقي إلى أن يثبت بها الفرض ، والتحريم ، وإنما الإيجاب ، وكراهة التحريم حتى وإن كانت دلالتها على طلب الفعل أو الترك قطعية ، وذلك لأن الفرض ، والتحريم إنما يثبتان بالدليل الذي يتوفر فيه قطعية الدلالة ، وقطعية الثبوت على عكس القرآن الكريم الذي هو قطعي الثبوت فإذا توفرت قطعية الدلالة على طلب الفعل فيكون فرضاً ، أو على طلب الترك فيكون تحريماً .
هذا عند الحنفية ولم يرتض بذلك جمهور العلماء [24] وهذا الخلاف ــ لدى المحققين ــ خلاف في التسمية والاصطلاح ، كما أنه خلاف باعتبار وصول الخبر إلينا ، فمثلا ً اعتبروا ” قراءة الفاتحة ” في الصلاة واجبة ، لأن تعيينها ثابت بالسنة الآحادية في نظرهم ، وهي قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) :” لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ” [25] في حين أن مطلق قراءة القرآن فيها فرض لقوله تعالى : (( فاقرؤا ما تيسر من القرآن )) [26] وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نقول ــ على ضوء قواعد الحنفية هذه ــ إن الصحابي الجليل الذي استمع من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هذا القول يكون حكم الفاتحة بالنسبة له فرضاً ، وبالنسبة لغيره يكون إيجاباً ، ولا يشهد على ذلك دليل يلزم غيرهم .
الأمر الرابع : تقسيم الفقهاء أقوال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ما قاله إفتاء ً ، أو باعتباره حاكماً إذا كان هذا صحيحاً بالنسبة للسنة القولية [27] ، فلا يمكن إجراؤه على القرآن الكريم ، لأن أحكامه عامة لا تُخصص إلا بدليل أو تكون هي خاصة .
ولتوضيح ذلك نقول : لا شك أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان المربي والمعلم ، والإمام ، والحاكم والمفتي للرعيل الأول ، فكان جامعاً بين المناصب الدينية والمناصب الدنيوية ، فكان يبين الأحكام والفتاوى ، كما كان يبعث الجيوش ، ويحكم بين الناس ويقضي بما أراه الله ومن هنا كانت بعض تصرفاته نابعة من كونه إمام المسلمين مثل إرساله الجيوش لقتال الكفار والمعتدين ، وصرف أموال بيت المال في مصارفها ، وتولية القضاة والولاة العامة ، وتقسيم الغنائم ، وعقد العهود والصلح بين دولة الإسلام وغيرها ، فمثل هذه التصرفات اتفق الفقهاء على أنها كانت بوصفه القائد والإمام الأعظم للمسلمين ، ولذلك لا يجوز لعامة المسلمين أن يقوموا بها إلا إذا أذن لهم الإمام ، اقتداء ً به عليه السلام ، ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضي ذلك ، وكذلك أقضيته وفصله في دعاوى الأموال والجنايات ونحوها بالبينات ، أو الأيمان ، والنكولات ونحوها … فنعلم أنه ( صلى الله عليه وسلم ) إنما تصرف في ذلك عن طريق كونه قاضياً ، فيكون مثل ذلك خاصاً بمن نصب قاضياً ، أو حكماً ، وليس عاماً .
وكذلك لا خلاف بين المسلمين في أن ما قاله الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على سبيل التبليغ كان ذلك حكماً عاماً على جميع الناس إلى يوم القيامة ، ولا يحتاج إلى أمر الحاكم أو إذنه ، أو حكم القاضي به ، فكل ما قاله أو فعله في بيان العبادات والشعائر ، وكذلك فتاواه العامة في المعاملات ونحوها من هذا الباب حيث يجوز أن يُقَّدِم َ عليه كل أحد بنفسه دون الحاجة إلى إذن من الإمام أو القاضي ، وكذلك المباحات ، وإن كان منهياً عنه اجتنبه كل واحد بنفسه دون الحاجة إلى نهي آخر [28] .
ولكن الفقهاء اختلفوا في عدة أحاديث نبوية هل قالها الرسول( صلى الله عليه وسلم ) بوصفه مبلغاً ورسولا ً ، أم بوصفه حاكماً وإماماً للمسلمين وقاضياً بينهم ؟
نذكر منها مثالين ، أحدهما لما ذكر بوصفه إماماً أعظم ، والثاني بوصفه قاضياً .
المثال الأول : قوله ( صلى الله عليه وسلم ) :” من أحيا أرضاً ميتة فهي له ” [29] حيث اختلف العلماء في هذا الحديث هل كان هذا القول صادراً منه ( صلى الله عليه وسلم ) باعتباره فتوى فحينئذ يجوز لكل واحد أن يحيي الموات سواء أذن الإمام في ذلك أم لا وهذا رأي مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبي يوسف ، ومحمد [30] . أم هو تصرف منه بوصفه الإمام ؟ أي أنه قد أذن إذناً عاماً ، وبالتالي يحق للناس الإحياء ، وعلى هذا أن إذا لم يأذن لا يجوز ، وهذا مذهب الحنفية [31] .
والذي يظهر لنا رجحانه هو أن هذا الحديث عام جار مجرى الفتوى والتبليغ ، إذ ليس هناك دليل يدل على هذا التخصيص ، كما أن الأصل في كلام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) هو التبليغ ، وذلك لأنه مهمته الأساسية ، يقول العلامة القرافي :” لأن وصف الرسالة غالب عليه ” [32] .
المثال الثاني : قولـــــه ( صلى الله عليه وسلم ) لهند بنت عتبـــة امرأة أبي سفيان : ” خــــذي أنت وبنوك بالمعروف ” قال لها هذا حينما جاءت إليه وقالت لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :” إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل عليَّ جناح أن آخذ من ماله سراً ” [33] .
فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة حيث ذهب جماعة منهم إلى أنه يجوز لكل زوجة لا يؤدي لها زوجها نفقتها بالكامل أن تأخذ حقها سراً بناء ً على أن قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) السابق فتوى عامة ، بل أجازوا لكل من هو صاحب حق وظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه بغير علم خصمه وهذا مذهب مالك في رواية ، وابن سيرين ، والليث [34] ، في حين ذهب آخرون [35] إلى أن الحديث الســــابق كان تصرفاً من النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالقضاء ، ولذلك أورده النسائي في كتاب آداب القضاة ، باب القضاء على الغائب [36] وهذا يعني أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كان قد قضى لهند بالحكم السابق ، وليس فتوى عامة ، فعلى ضوء هذا لا يجوز لأحد أن يأخذ حقه ، أو جنس حقه إذا تعذر أخذه من الغريم إلا بقضاء قاض .
والذي يظهر أن هذا التصرف منه ( صلى الله عليه وسلم ) كان فتوى عامة ، وذلك لأنه لو كان قضاء ً لكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) طلب إجراءات القضاء من إثبات الدعوى وإحضار أبي سفيان الذي كان موجوداً داخل مكة آنذاك ، ولذلك ترجم له البخاري : باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ، ثم استدل بما قاله ابن سيرين : يقاصُّه ، وقرأ : (( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) [37] قال ابن حجر :” وقد جنح المصنف إلى اختياره ــ أي اختيار أن يأخذ المظلوم بقدر الذي له ، ولو بغير حكم حاكم ــ ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار … وهذا الأثر وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ :” إن أخذ أحد منك شيئاً فخذ مثله ” . وقد احتج البخاري بحديثين : أحدهما : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة هند . والثاني حديث عقبة بن عامر قال : قلنا للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فيه ؟ فقال لنا :” إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ” [38] وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف واجب ، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً ، وقال به الليث مطلقاً ، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى [39] . قال ابن بطال :” حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه ، أو جحده قدر حقه ” [40] . وقد أورد البخاري لحديث هند باباً آخر ترجم له : باب إذا لم ينفق الرجل ، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف ، قال الحافظ ابن حجر : ” أخذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب بطريق الأولى لأنه دل على جواز الأخذ لتكملة النفقة ، فكذا يدل على جواز أخذ جميع النفقة عند الامتناع [41] . وقد حاول بعض الفقهاء أن يجعل هذه القصة من باب القضاء على الغائب ، فرد عليهم الإمام النووي بقوله :” ولا يصح الاستدلال ، لأن هذه القصة كانت بمكة ، وكان أبو سفيان حاضراً بها ، وشروط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد ، أو مستتراً لا يقدر عليه ، أو متعززاً ، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداً فلا يكون قضاء ً على الغائب ، بل هو إفتاء ، وقد وقع كلام الرافعي في عدة مواضع أنه كان إفتاء . وقال ابن حجر :” نعم قول النووي : إن أبا سفيان كان حاضراً بمكة حق ، وقد سبقه إلى الجزم بذلك السهيلي ، بل أورد أخصَّ من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالساً معها في المجلس ، لكن لم يسق إسناده ، وقد ظفرت به في طبقات ابن سعد أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل عن الشعبي [42] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
انظر : فتح القدير ( 1/448 ) وحاشية الدسوقي ( 1/138 ) والمجموع ( 2/65 ) والمغني ( 1/147 ) .
-
وقد جمع السيوطي هذه الأحاديث في كتاب خاص .
-
يراجع في تفصيل ذلك : الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق الشيخ شاكر ، فقرة ( 918 ــ 1269 ) والإحكام للآمدي ، ط . محمد علي صبيح بالقاهرة ( 1/234 ـ 270 )، الفصول في الأصول للجصاص ، تحقيق د. عجيل النشمي ط . الأوقاف بالكويت ( 3/75 ــ 123 ) البرهان لإمام الحرمين ، تحقيق د . عبد العظيم الديب ط . قطر ( 1/599 ) والمحصول للرازي تحقيق د . طه جابر العلواني ( ج 2 ق 1/507 ) ، والمنهاج للبيضاوي مع شرحيه للإسنوي ، والبدخشي ، ط . محمد علي صبيح بالقاهرة ( 2/212 ) وبيان المختصر شرح مختصر بن الحاجب ، ط . جامعة أم القرى ( 1/656 ) وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ، تحقيق د . محمد زكي عبد البر ط . دار الكتاب العربي ( 2/370 ) والبحر المحيط للزركشي ، مخطوطة دار الكتب ( تيمور 101 ) ج 2 ، ورقة ( 155 ــ 180 ) .
-
المصادر السابقة نفسها .
-
الإحكام للآمدي ( 1/254 ) .
-
سورة نوح الآية ( 1 )
-
سورة النساء الآية ( 163 ) .
-
الرسالة ص ( 435 ــ … ) .
-
الحديث رواه أحمد ( 1/436 ، 437 ، 3/225 ) والترمذي ( 3/372 ) والمستدرك ( 1/86 ، 88 ) ، وقال الهيثمي في المجمـــع ( 1/137 ) :” رواه البزار ، ورجاله موثقون ، إلا أن يكون شيخ سليمان بن سيف : سعيد بن بزيع فإني لم أر أحداً ذكره ، وإن كان سعيد بن الربيع ــ وهو من رجال الصحيح ــ روى عنهما ” .
-
الرسالة ص ( 401 ــ 457 ) .
-
صحيح البخاري ــ مع الفتح ــ ( 13/231 ــ 244 ) .
-
فتح الباري ( 13/236 ) .
-
البرهان ، فقرة ( 540 ) .
-
المصادر الأصولية السابقة أنفسها ، في باب النسخ ، ويراجع تفصيل ذلك في البحر المحيط للزركشي ج 2 ورقة 86 .